مكّنت الثورة الرقمية المعلومات من الانتشار على نطاق أوسع وبسرعة أكبر من ذي قبل. يحذّر جوزيف ناي من أنّ القوّة الناعمة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى. ففي كتاباته الرائدة السابقة، وضع ناي مصطلح "القوّة الناعمة" ليصف بُعداً جديداً للقوّة يتجاوز القوّتين الاقتصادية أو العسكرية، حيث تشير القوّة الناعمة إلى قدرة بلد معيّن على فرض أجندته في مضمار السياسة العالمية واجتذاب الدول الأخرى نحوها. لكن مع تضخم ما يعرف بـ"مفارقة الوفرة" الناشئة بسبب الإنترنت، أصبح سر المقدرة على تشكيل الرأي العام، وهو العنصر الأساسي في تشكيل القوة الناعمة 2.0، يكمن في القدرة على المنافسة على الموارد النادرة المتمثلة بجذب الانتباه وتحقيق المصداقية.
في أوروبا القرن التاسع عشر، كان معيار القوّة العظمى يتمثّل في القدرة على بسط السيطرة الحربية، وهكذا كان رجال الدولة يحسبون ميزان القوى. أمّا في عصر المعلومات العالمي اليوم، فإنّ النصر لا يعتمد أحياناً على جيش من ينتصر، وإنمّا قصّة من هي التي تسود. فالسردية الجيّدة تحفّز الناس وتشدّ اهتمامهم. وللقلوب والعقول دور هام. كما أنّ للقدرات العسكرية أهميتها هي الأخرى، لكنّها غير كافية. فالجيش القوي لا يمنح القوّة على الإنترنت.
تمنحُ المعلوماتُ القوّة. وثمّة اليوم عدد أكبر من الناس القادرين على الحصول على كمّ أكبر من المعلومات أكثر من أي وقت سبق، لاستخدامها سواء للخير أو الشر. ولا يقتصر استخدام هذه المعلومات على الحكومات فقط، بل هي متاحة للأطراف الفاعلة من غير الدول، سواء الشركات الكبيرة، أو المؤسسات غير الربحية، أو المجرمين، أو الإرهابيين، أو المجموعات غير الرسمية المشكّلة لأغراض خاصّة. هذا الدور للأطراف الفاعلة من غير الدول لا يعني نهاية الدولة الوطنية، حيث أنّ الحكومات تبقى اللاعب الأقوى على الساحة العالمية. إلا أنها اليوم باتت ساحة مكتظة، ويمكن للعديد من هذه الأطراف الفاعلة الأخرى أن تتنافس بفعالية في حقل القوّة الناعمة. فالقوى البحرية القويّة هامة في السيطرة على الخطوط البحرية، لكنّها غير قادرة على المساعدة كثيراً في عالم الإنترنت الافتراضي، وقلّة من الدول فقط تمتلك مثل هذه الأساطيل. ويجب لذلك على الحكومات الناجحة الاستثمار في جميع أبعاد القوّة، بما في ذلك القوّة الناعمة.
القوّة هي القدرة على التأثير في الآخرين للحصول على ما تريده، وبوسعك فعل ذلك بثلاث طرق رئيسية:
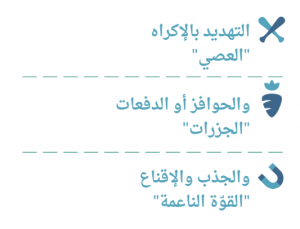
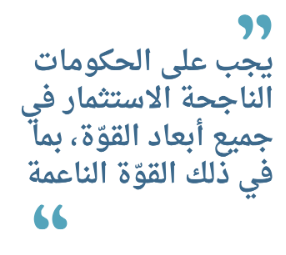
فقد يبلي بلد ما بلاءً حسناً في السياسة العالمية لأنّ الدول الأخرى تريد السير على خطاه، وتعجب بقيمه، وتقلّد نموذجه، وتطمح إلى تحقيق مستوى الازدهار الموجود فيه. ورغم أنّ العديد من الحالات في عالم الواقع تشمل الأنماط الثلاثة من القوّة، ونادراً ما تكون القوّة الناعمة كافية لوحدها، إلا أنّ حضورها يمكن أن يكون عامل مضاعفة للقوّة. فمن المهم أن يكون البلد قادراً على تحديد الأجندة، وخطب ود الدول الأخرى في مجال السياسة العالمية، وليس فقط إجبارها على التغيير من خلال التهديد أو استعمال الأسلحة العسكرية أو الاقتصادية. وهذه القوّة الناعمة – التي تدفع الآخرين إلى الرغبة بالوصول إلى المحصلات التي تريدها – تجعلك تكسب الناس إلى صفّك عوضاً عن تعريضهم للإكراه. فإذا كنت تمتلك القوّة الناعمة، فإنك ستقتصد في استعمال العصي والجزرات الموجودة لديك. والنجاح في الجمع بين القوّة الخشنة والقوّة الناعمة هو القوّة الذكية.
في بعض الأحيان، يعتقد الناس بأنّ القوّة الناعمة غير متاحة إلا للدول الكبيرة مثل الولايات المتحدة أو الصين والتي لديها اقتصادات كبيرة، أو قادرة على توجيه بثّها إلى العالم، لكنّ ذلك غير صحيح. فالعديد من الدول الصغيرة مثل النرويج أو سنغافورة تمتلك قوّة ناعمة على الرغم من أنّ تعداد السكّان فيهما لا يزيد على خمسة ملايين نسمة. وهذا لا يجعل هذه الدول في مصاف دولة مثل بريطانيا، لكنّه يسمح لها بتوجيه لكمات تزيد عن وزنها، كما يُقال مجازاً. وهذا الأمر قد يصحّ على دول الخليج أيضاً.
تتوقّف القوّة الناعمة على القدرة على تشكيل خيارات الآخرين. وهي ليست ملكاً لأي دولة واحدة بمفردها، كما أنّها ليست حكراً على الدول فقط. فعلى سبيل المثال، تستثمر الشركات في علاماتها التجارية بقوّة، وغالباً ما يهاجم الناشطون غير الحكوميين العلامات التجارية للشركات بهدف الضغط عليها لتغيير ممارساتها. وتحاول المنظمات غير الربحية إدارة صورتها بهدف زيادة قوّتها الناعمة. وفي السياسة الدولية، تعتمد القوّة الناعمة لبلد من البلدان بصورة رئيسية على ثلاثة مصادر: ثقافته (في الأماكن التي تكون فيها جذّابة للآخرين)، وقيمه السياسية (عندما تطبيقها داخلياً وخارجياً)، وسياساته الخارجية (عندما يُنظر إليها على أنّها مشروعة وتتمتّع بالسلطة الأخلاقية). وتنتشر القوّة الناعمة على نطاق واسع وعلى جميع مستويات السلوك البشري من الأفراد إلى الأمم، ومن المرجّح أن تتزايد أهميتها بسبب ثورة المعلومات التي نمر بها.
القوّة الناعمة في العصر الرقمي
ليست ثورات المعلومات وتأثير وسائل الإعلام الجماهيرية بالأمر الجديد، حيث يجدر بنا أن نراقب التأثيرات الدراماتيكية التي تسبّبت بها مطبعة غوتنبرغ في أوروبا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. لكنّ ثورة المعلومات الحالية تغيّر من طبيعة القوّة وتزيد من توزّعها وانتشارها. ويمكننا القول بأنّ ثورة المعلومات الحالية تعود جذورها إلى "قانون مور" الذي نشأ في وادي السيليكون في ستينيات القرن الماضي، والقائل بإنّ أعداد الترانزستورات الموضوعة على رقاقة حاسوب واحدة تتضاعف كل عامين. ونتيجة لذلك، فإن قوّة الحوسبة تزايدت تزايداً دراماتيكياً، وبحلول بداية القرن الحادي والعشرين، باتت تكلفتها تعادل واحداً على ألف من تكلفتها في مطلع سبعينيات القرن الماضي. في عام 1993، كان هناك ما يُقارب 50 موقعاً على الإنترنت في العالم؛ وبحلول عام 2000 ارتفع العدد إلى 5 ملايين. أمّا اليوم، فإنّ عدد مستعملي الشبكة العنكبوتية يزيد على ثلاثة مليارات ونصف المليار نسمة؛ وبحلول عام 2020، من المتوقع أن ينمو هذا الرقم إلى خمسة أو ستة مليارات إنسان، كما ستربط "إنترنت الأشياء" ما بين عشرات مليارات الأجهزة.
ولا تشكل "سرعة" الاتصال السمة الأساسية لثورة المعلومات هذه: فقبل قرن ونصف القرن خلت، أصبح التواصل الفوري متاحاً بواسطة البرقيات (التيليغراف) بين أوروبا وأميركا الشمالية. إنما يكمن التغيير الأساسي في التراجع الهائل في "تكلفة" نقل المعلومات وتخزينها. ولو كان سعر السيّارة قد تراجع بالسرعة ذاتها التي تراجعت بها قوّة الحوسبة، لكان بإمكان المرء اليوم أن يشتري سيارة بذات سعر شطيرة هامبرغر بيغ ماك. وعندما يتراجع ثمن التكنولوجيا بهذه السرعة، فإنها تصبح متاحة على نطاق واسع، بينما تنخفض العوائق أمام تبني هذه التكنولوجيا.
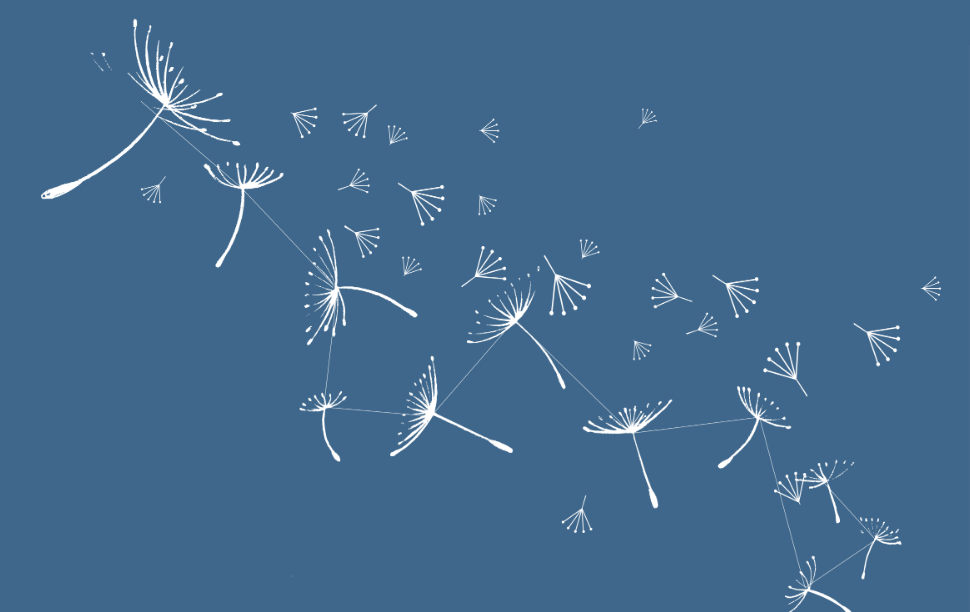
لا حدود اليوم فعلياً لحجم المعلومات التي يمكن نقلها على نطاق العالم بأسره، بالنسبة للمعلومات المتعلقة بكل الأغراض العملية الشائعة. كما شهدت تكلفة تخزين المعلومات تراجعاً هائلاً، الأمر الذي مكّن من وصولنا إلى حقبة البيانات الضخمة التي يمكن للذكاء الاصطناعي معالجتها. والمعلومات التي كانت تملأ مخزناً يوماً ما، بات بوسعك أن تضعها في جيب قميصك. في أواسط القرن العشرين، كان الناس يخشون من أن تقود الحواسيب والاتصالات المرتبطة بثورة المعلومات الحالية إلى إنشاء سيطرة حكومية مركزية، وهي الحالة التي أخذت بعداً درامياً في رواية جورج أورويل الشهيرة "1984" التي تحدّثت عن حالة بائسة للدولة. ولكن بدلاً من ذلك، ومع تراجع تكلفة قوة الحوسبة وتضاؤل حجم الحواسب التي باتت بحجم الهواتف الذكية، والساعات، وغير ذلك من الأجهزة المحمولة، فإن تأثيراتها في نشر اللامركزية فاقت بأشواط تأثيراتها في إضفاء المركزية. ومع ذلك، فإنّ المفارقة تكمن في أنّ هذا الاتجاه التكنولوجي أعطى للرصد والمراقبة بعداً لامركزياً بحيث بات الناس الآن يحملون طوعاً جهازاً للتعقّب في جيوبهم يستمر في خرق خصوصيتهم في معرض بحثه عن الأبراج الخليوية. كما تخلق شبكات التواصل الاجتماعي الواسعة الانتشار مجموعات جديدة عابرة للحدود، وفرصاً مفتوحة لممارسة التلاعب سواء من الحكومات أو غيرها.
دبلوماسية عامّة جديدة
تتزايد أهمية الدبلوماسية العامّة والقدرة على الاجتذاب والإقناع، لكنّ الدبلوماسية العامّة ذاتها تتغيّر. وقد فات أوان اليوم الذي كانت فيه الدبلوماسية العامّة بصورة أساسية هي البث الإذاعي والتلفزيوني. إذ قادت التطوّرات التكنولوجية إلى تراجع دراماتيكي في تكلفة معالجة المعلومات ونقلها. والنتيجة هي حصول انفجار في المعلومات، وهذا أنتج ما يعرف بـ"مفارقة الوفرة" على الإنترنت، حيث تقود وفرة المعلومات إلى ندرة الانتباه. وعندما يشعر الناس بالتخمة من حجم المعلومات التي يواجهونها، يصعب معرفة ما يجب التركيز عليه. ويصبح "الانتباه"، وليس المعلومات هو المورد النادر. وتصبح السمعة حتّى أهم مما كانت عليه في الماضي، وتنشأ الصراعات السياسية (المتأثرة بالارتباطات السياسية والاجتماعية) على خلق المصداقية أو هدمها. ويمكن مثلاً لشبكات التواصل الاجتماعي أن تجعل المعلومات الزائفة تبدو أكثر مصداقية إذا ما أتت من "أصدقاء". فقد تمكّنت روسيا على سبيل المثال، من تحويل شبكات التواصل الاجتماعي الأميركية إلى سلاح للتدخّل في انتخابات عام 2016 في أميركا.
عندما تنحسر القوّة الناعمة: القوة الناعمة الأميركية مثالاً
لطالما كانت السمعة هامّة في السياسة العالمية، لكنّ دور المصداقية بات أكثر أهمية كمصدر للقوّة. والمعلومات التي تبدو على أنها دعائية (بروباغاندا)، قد لا تحظى بالازدراء فحسب، وإنما قد يتبيّن بأنها قد تأتي بنتائج عكسية إذا كانت تقوّض سمعة بلد من البلدان أو مصداقيته. فخلال حرب العراق، على سبيل المثال، قادت معاملة سجناء أبو غريب بطريقة لا تتوافق والقيم الأميركية، إلى تعميم تصوّرات بالرياء والنفاق لا يمكن عكسها أو قلبها بمجرّد بث صور لمسلمين يعيشون عيشة طيبة في أميركا. واليوم، نرى أن "التغريدات" الرئاسية التي يتّضح زيفها بكل جلاء تحدّ من المصداقية الأميركية وتقلل من القوّة الناعمة. ففعالية الدبلوماسية العامة تقاس بالآراء التي تغيّرت (والتي تقاس بدورها بالمقابلات أو استطلاعات الرأي)، وليس بحجم الدولارات المنفقة أو الرسائل المرسلة.
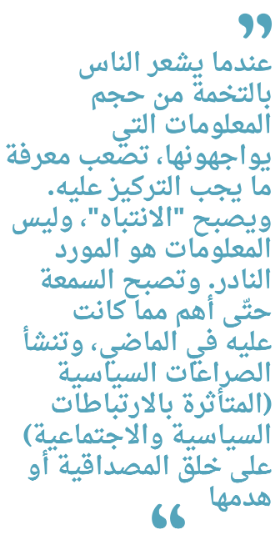
ومع سعي الدول الأخرى إلى دراسة خططها للاستثمار في القوّة الناعمة، من المفيد أن تلاحظ ما حصل للقوّة الناعمة الأميركية خلال العامين الماضيين. فقد أظهرت استطلاعات الرأي ومؤشر بورتلاند لـ "القوّة الناعمة 30" حصول تراجع في القوّة الناعمة الأميركية منذ بداية عهد الإدارة الأمريكية الحالية. إذ يمكن للتغريدات أن تساعد في تحديد جدول الأعمال العالمي، لكنّها لا تنتج قوّة ناعمة إذا لم تكن جذّابة. ويجيب المدافعون عن الإدارة الأمريكية الحالية بأنّ القوّة الناعمة لا تهم. فقد أعلن مثلاً مدير الموازنة في هذه الإدارة، ما أسماه "موازنة القوّة الخشنة" في معرض خفضه لتمويل وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بنسبة 30%. بينما حذّر وزير الدفاع الأميركي الكونغرس من أنّه إذا لم يوفّر الأموال لدعم القوّة الناعمة عبر وزارة الخارجية، فإنّه سيضطر لتزويده بالمزيد من الذخيرة.
يمكن للسياسات المحلية أو الخارجية التي تبدو منافقة أو صلفة أو لامبالية بآراء الآخرين، أو تستند إلى تصوّر ضيّق للمصالح الوطنية والقومية أن تقوّض القوّة الناعمة. فعلى سبيل المثال، كان ثمّة تراجع حاد في جاذبية الولايات المتحدة الأميركية في استطلاعات الرأي التي جرت بعد غزو العراق في 2003. وفي السبعينيات، عارض الكثير من الناس حول العالم الحرب الأميركية في فيتنام، كما عكست المكانة العالمية لأميركا عدم الشعبية التي تحظى بها تلك السياسة. يحاجج المشكّكون بأنّ هذه الدورات تظهر بأنّ القوّة الناعمة ليست هامّة كثيراً، لأن الدول تتعاون بدافع المصالح الذاتية. لكنّ هكذا حجّة تفتقر إلى نقطة أساسية، ألا وهي أنّ التعاون هو مسألة متدرجة، وأن هذا التدرج يتأثر سلباً أو إيجاباً بالجاذبية أو النفور.
لحسن الحظ، فإنّ القوّة الناعمة للبلد لا تتوقف على سياسات حكومته، وإنما تعتمد أيضاً على مدى جاذبية مجتمعه المدني. وعندما كان المحتجّون في الخارج يتظاهرون ضدّ حرب فيتنام، كانوا ينشدون نشيد "سوف نتغلّب" الذي تبنّته حركة الحقوق المدنية الأميركية. ونظراً لتجارب الماضي، فإنّ هناك كل الأسباب التي تدعوا للاعتقاد بأنّ الولايات المتحدة سوف تستعيد قوّتها الناعمة بعد انقضاء فترة الإدارة الحالية. هذه كلها أمور يتوجب على الدول أن تأخذها بالحسبان عندما تدرس استثماراتها في القوّة الناعمة.
جوزيف إس. ناي هو أستاذ الكرسي الجامعي المميّز في كلية كينيدي للإدارة الحكومية في جامعة هارفارد ومؤلف كتاب "مستقبل القوّة" (The Future of Power). اقرأ كامل السيرة الذاتية عبر الضغط هنا.













يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.